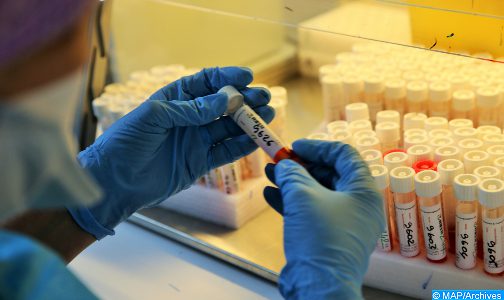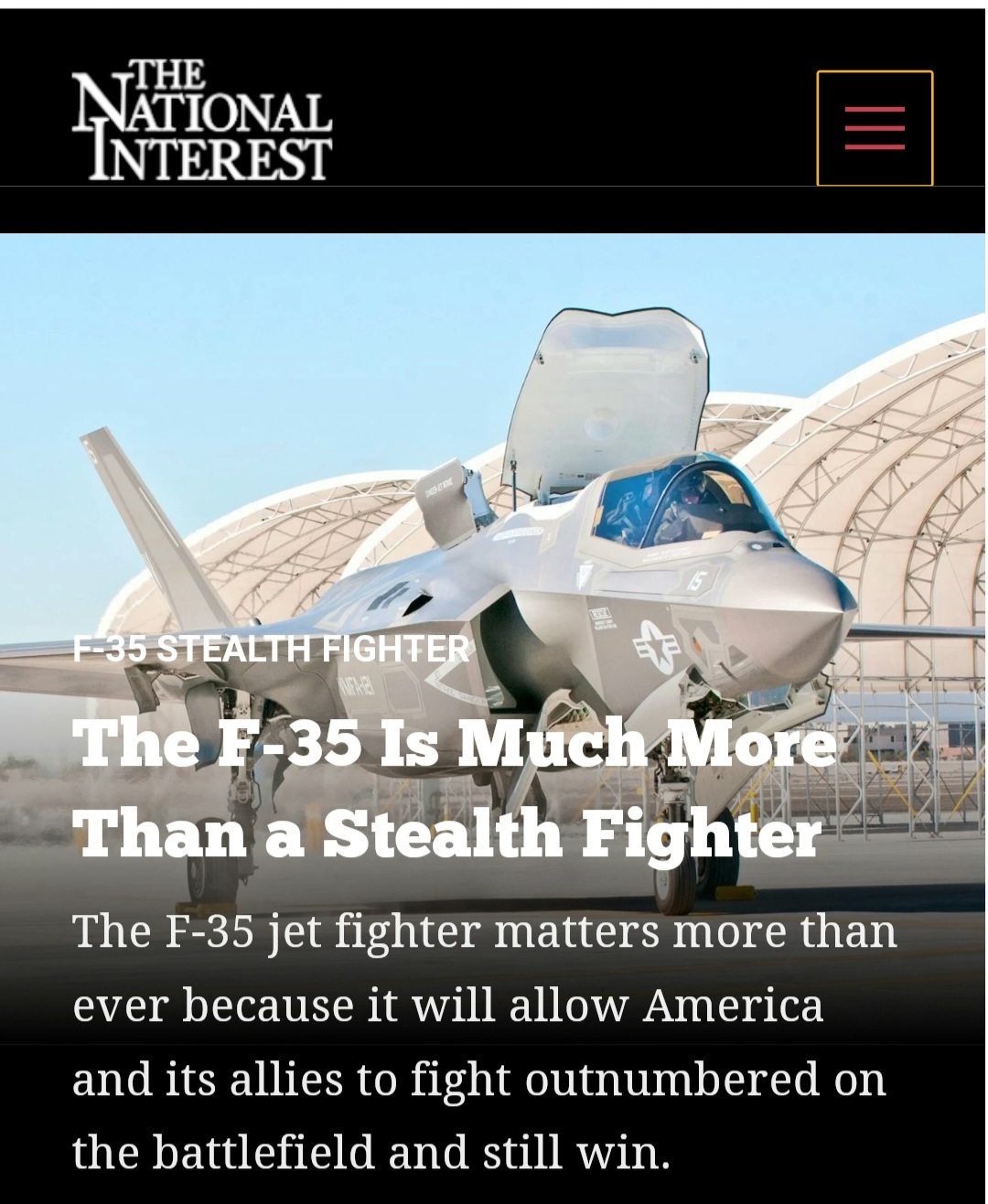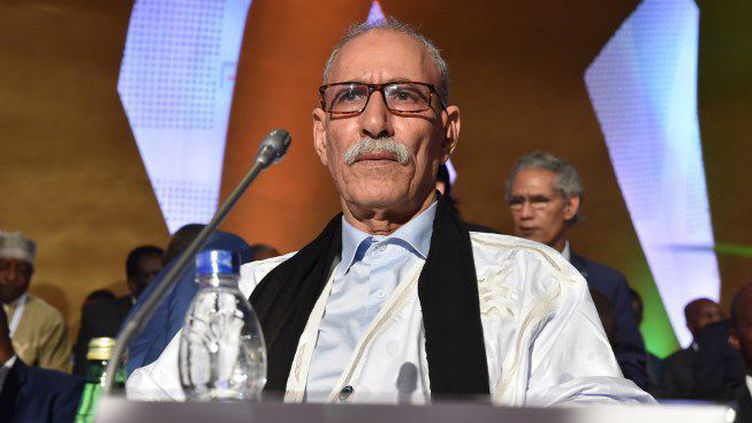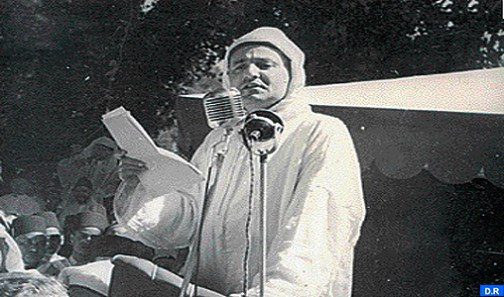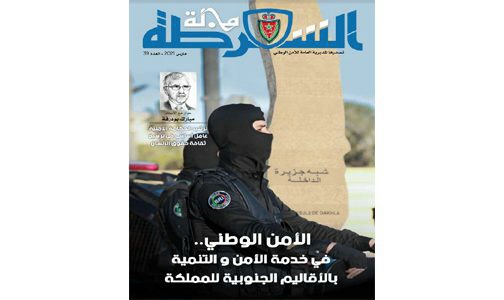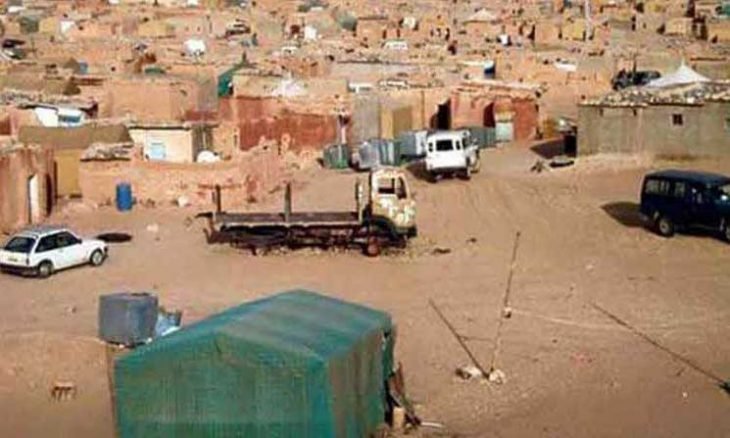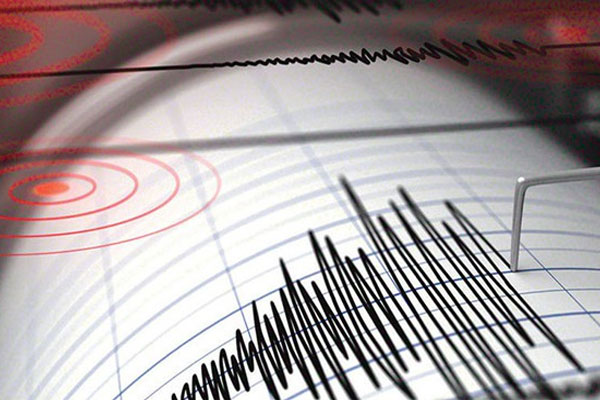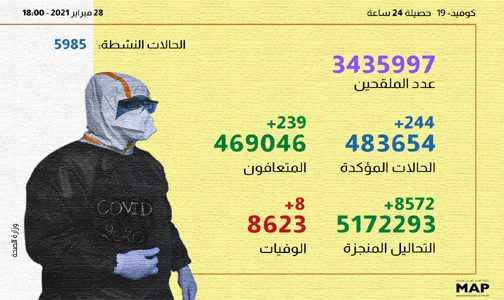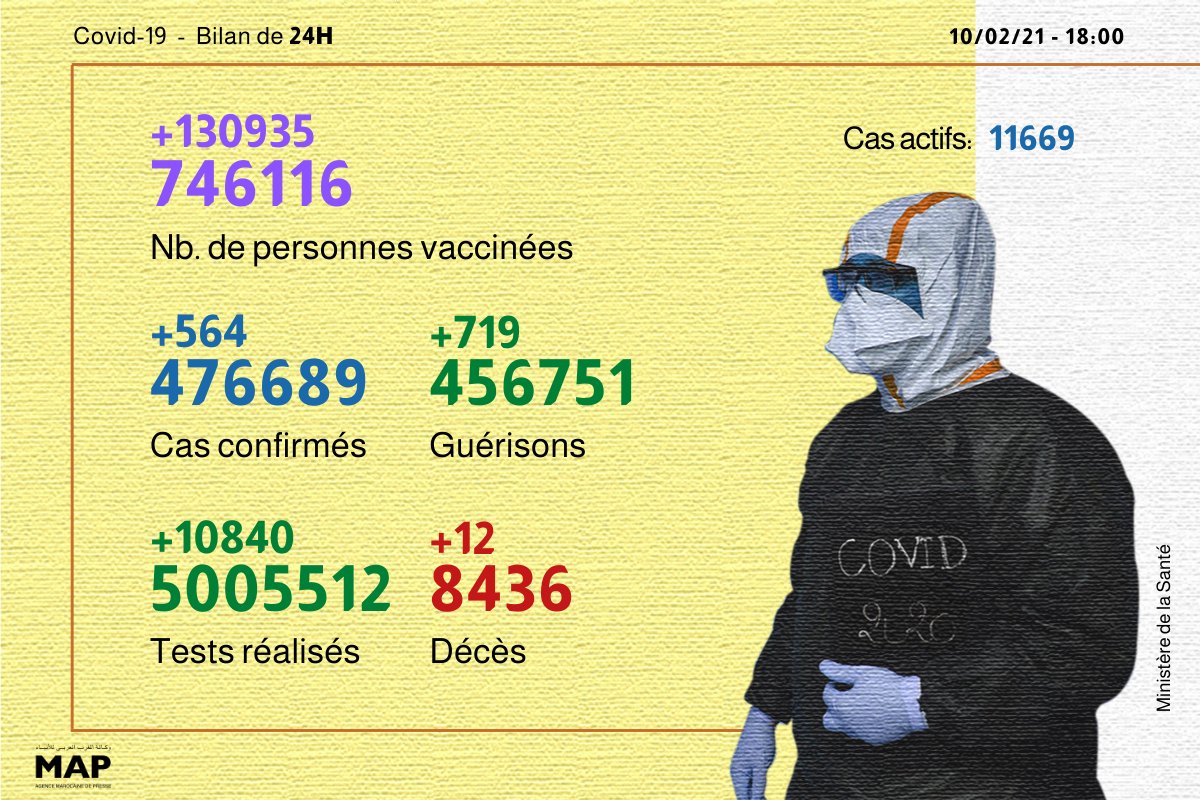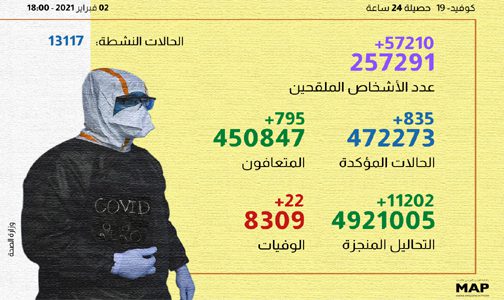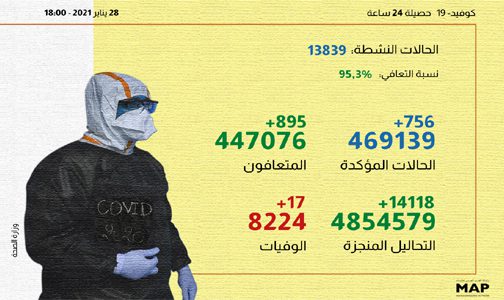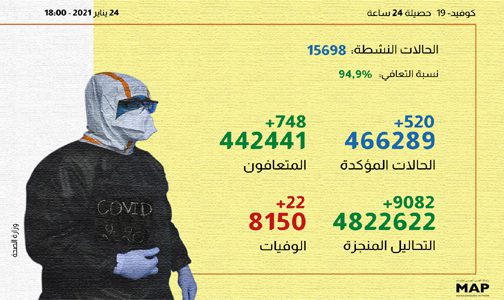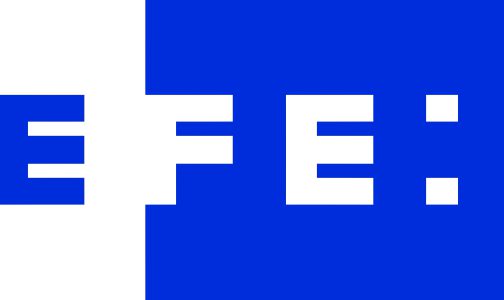فيديو: ولي العهد مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ17 للمعرض الدولي للفلاحة
بقلم: جمال الموساوي
الارتباك. كلمة قد تلخص لوحدها حالتنا اليوم. هناك الكثير من التفاصيل التي تطفو إلى سطح الحياة اليومية لتؤكد بلا أي مجال للشك أن البوصلة لم تعد تشير إلى شيء محدد.
سياسيا،
لم يعد خافيا أن الأغلبية الحكومية تشتغل بمنطق الجزر المعزولة، كل جزيرة تحاول “تقرير مصيرها” والحصول على “استقلال ذاتي” يمكنها من الدفاع عن مصالحها، السابق منها واللاحق. والمتتبع سيلاحظ أن الأطراف كلها تستبق الوقت لكسب مساحات وهوامش للمناورة لتلمع أكثر صورتها أمام الرأي العام خاصة أن ثمة استحقاقات في الطريق، ولا أحد يريد أن يتعرض لحادث سير وهو يحاول تعبيد الطريق إلى المجالس المحلية والجهوية وإلى مجلس المستشارين. الصحافة الوطنية، على اختلاف توجهاتها، حاصل بينها إجماع على أن الأغلبية الحكومية تسير بشكل حثيث نحو الحائط… والأكيد أن هذا التوقع، إذا تحقق، سيزيد الطين بَلّة وسيساهم في الرفع أكثر من درجة الالتباس.
اقتصاديا،
بعد البرامج الطموحة لكل الأحزاب، بخصوص أرقام النمو والبطالة، يبدو أن كل الأطراف نزلت إلى الأرض، لأن الواقع بات واضحا أكثر، وأن الأماني لن تغيره حتى وإن قدمت بشأنه بعض الأحلام الجميلة. نحن أمام سنة عجفاء. الأزمة الاقتصادية التي تعم العالم من أقصاه إلى أدناه من المستغرب ألا تتخطى حدودنا وتلج إلينا بكل ما تحبل به من تداعيات سواء على سوق الشغل أو على الاستثمار أو على مداخيل الأسر التي تجد نفسها في ضيق، وأن شروط عيشها تسوء يوما عن يوم… هذا يعني أن حبل التفاؤل تآكل بسرعة، وهو طرح تؤكده الخرجة الأخيرة لوالي بنك المغرب الذي أعلن بكل وضوح أن سنة 2012 ستكون سنة أزمة، فقد لا تصل نسبة النمو إلى 3 في المائة، وهو ما يعتبر أمر حتميا إذا أخذنا في الاعتبار تقديرات الشركاء الاقتصاديين للمغرب، حيث من المتوقع ألا تتجاوز النسبة في فرنسا 1 في المائة في أفضل الأحوال، حسب ما أعلنته الحكومة الفرنسية، أما أرقام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فتذهب إلى أقل من ذلك. ففي توقعاتها المتعلقة بسنتي 2012 حددت المنظمة نسبة النمو في فرنسا وفي إسبانيا، في 0.3 في المائة، وأعلنت أن هذه النسبة لن تتجاوز في في منطقة الأورو 0.2 في المائة، واعتبارا لتوجه المغرب ولارتباطه أكثر بهذا الفضاء فمن المؤكد أن رذاذ الأزمة، على الأقل، سيغطي على التفاؤل الذي ظل المسؤولون في المغرب يتمسكون به حتى الآن.
اجتماعيا،
ما من شك في أن للالتباس السياسي والاقتصادي كبير أثر على المستوى الاجتماعي، ولعل اختلاط الحابل بالنابل في الشارع، يدل أكثر من غيره على درجة الالتباس التي يعيش فيها المغرب اليوم. إنه لم يعد مفهوما ما يريده الشارع المغربي بالضبط والتحديد. لقد ضاع المطلب الاجتماعي في المطلب السياسي والعكس صحيح، والاقتصادي في السياسي والعكس صحيح أيضا، وأصبحنا في حالة قريبة من “اللامطلب” ربما. ذلك أنه بدل أن تسير حركة الشارع نحو مطالب أكثر وضوحا ودقة، وجعل التفاوض بشأنها من موقع قوة، ألقت بكل أوراقها دفعة واحدة لكن بشكل غير منسجم ولا منسق، بحيث ضاعت وسط التجاذبات المختلفة الخفية والمعلنة، الشخصية والفردانية منها والجماعية.
ثقافيا،
لا يمكن فقط الحديث عن ارتباك، بل عن حالة من الشرود الكامل للفاعل الثقافي. هناك الكثير من الجدل بشأن أشياء شتى، وهو جدل ليس جديدا بأي حال، لكن قلة فقط من الفاعلين الثقافيين من يشارك فيه، وهم في الغالب أفراد يساهمون في النقاش دون أن تسندهم مؤسسة ما، وبالتالي تبقى مساهماتهم تعبيرا عن آراء معزولة قد لا تجد، مهما بلغت وجاهتها، من يتبناها، أو يصغي إليها على الأقل، وهنا تحديدا يبرز دور المؤسسات في تأطير النقاش المجتمعي، وهو تأطير لا يعني بأي حال توجيها له أو تأثيرا فيه بل يعني وضعه في سياق جماعي يروم إثارة الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها وطرح بدائل لما هو موجود حاليا ولا يتماشى مع التوجه العام للمجتمع، وليس بالضرورة للدولة، أي ما يتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية والحقوق والمواطنة. هذه الأسئلة لن يجيب عنها فرد بعينه بل على المؤسسات الثقافية أن تضع نفسها في قلب الدينامية التي يشهدها المجتمع على مستوى الوعي، وعلى مستوى ممارسة حقوقه في المواطنة.
والحال أن هذه المؤسسات لم تنخرط بشكل فعلي في هذا النقاش، لتنوب عنها، بشكل واضح الصحافة التي يبدو أنها وضعت نفسها في الخط الأمامي لهذه الجبهة لتغطي عن الغياب الصارخ للمؤسسات الثقافية المنشغلة أساسا بالعمل في الهامش من خلال أنشطة هنا وهناك، ونشر كتب بشكل مناسباتي، إضافة إلى انشغال الفاعل الثقافي الفردي نفسه بالبحث عن مسالك تتيح له الاستفادة من حالة الارتباك والضبابية المخيمة على المشهد الثقافي.
إن التهافت، ولنقل ذلك صراحة، هو سيد المشهد بامتياز وهو سبب التراجعات المسجلة في ما يتعلق بسير المؤسسات الثقافية، بما فيها الجمعيات الثقافية التي لا ينكر أحد أنها لعبت في أوقات سابقة من تاريخ المغرب أدوارا كبيرة في إذكاء الوعي وجعل الناس يتفاعلون مع العالم وما يروج فيه من أفكار وإيديولوجيات في زمن كانت فيه كل المنافذ مغلقة أمامهم.
إن تراجع الفاعل الثقافي إلى الوراء وانشغاله بنفسه، ساهم بالمقابل في تراجع تأثيره على سير الأمور في المجتمع، فلم تعد له تلك السلطة الرمزية التي تمتع بها في الماضي، ولا يزال هناك من يتمتع بها في أماكن أخرى من العالم… ولعل هذا التراجع هو ما يذكي أكثر زمن الارتباك، ويجعلنا في حاجة إلى وقت إضافي، زيادة على كل الوقت الذي مر حتى الآن، من أجل أن نرى بوضوح.